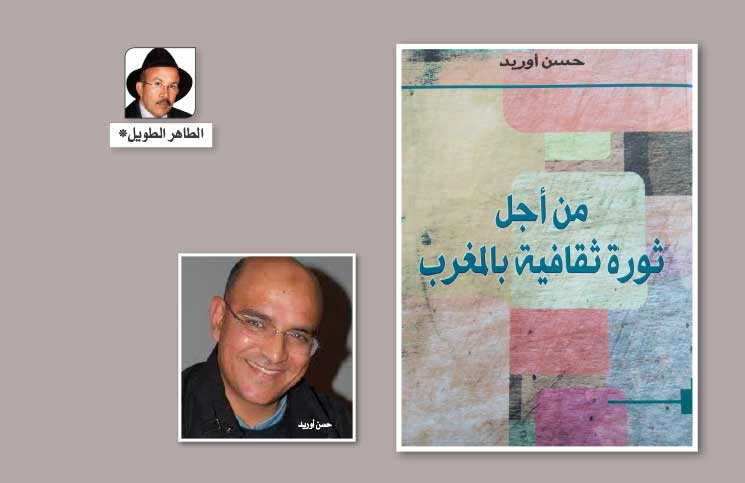ما إن نتجاوزُ العتبة الأولى لكتاب «من أجل ثورة ثقافية بالمغرب»، ونبدأُ في الغوص بين ثناياه، حتى ندرك أن أساس الثورة الثقافية التي ينادي بها مؤلفه حسن أوريد تربوي بالدرجة الأولى، وأن التربية ــ علاوة على ذلك ــ عملية سياسية بالمعنى العام والنبيل للكلمة، أي إنها ملازمة للشأن العام، ولا يكتمل أيُّ إصلاح سياسي منشود إلا بها، كما أن إصلاح المنظومة التربوية مسألةُ قرار سياسي بامتياز.
الكتاب الذي بين أيدينا اليوم، يمكن أن ندرجه ضمن ما يُطلق عليه «فلسفة التربية»، التي تروم إدراكَ المفاهيم والمشكلات التربوية بصورة واضحة ودقيقة وعميقة، كما تساعد على تصوّر التفاعل بين الأهداف والأغراض التربوية والمواقف التربوية المحددة والرابط بينها لتوجيه القرارات، مثلما يقول أحد الخبراء.
ولفلسفة التربية ثلاثة مرتكزات، ثقافي واجتماعي وبيولوجي (مرتبط بمراحل النمو لدى المتعلم)، وهي رؤية نجد تجلياتها بين ثنايا هذا الكتاب الذي يمكن اعتباره من بين الكتب المؤسّسة التي لا تكتفي بالتنظير، وإنما تقترح خطوات عملية لتنفيذ تلك التصورات.
يوضح المؤلف في مقدمة الكتاب أن مسألة التربية تهم الدولة في الأساس. إنها قضية استراتيجية وحيوية لا يمكن أن تتنكّب عنها، أو أن تتنازل بشأنها أو تُسندها للفيف أو فئة محدودة أو تسلمها للغير أو استثمار الباطن. فالتربية أداة الدولة لترسيخ بناء الأمة، وتقوية لُحمتها، ورسم معالم المجتمع، ووسيلتها لتكوين أطرها ونخبتها التي بها ضمانُها واستمراريتها، بل هي أداتها للارتقاء بالإنسان بزيادة وعيه.
ومن ثم، يحدد المؤلف خيارين لا ثالث لهما، من أجل الأخذ بأحدهما: إما اعتمادُ مدرسة لا نرسم معالمها، وتقودنا إلى حيث تشاء من التمايزات الثقافية والطبقية، تغذي الأحقاد، وتشكل عبئا ماليا، ونسعى بمَراهِــمَ أن نخفّف من خللها، ولكنها منقلبة علينا لا محالة، تُفرخ عاطلين حاقدين أو معطلين جانحين. أما الخيار الثاني، فيتمثل في إيجادِ مدرسة، نرسُم لها غايات فكرية وسياسية، وتنصهر فيها التمايزات، وتهيئ لتدبير الاختلافات، وتكونُ أداة للارتقاء الاجتماعي، وتكوّن كفاءاتٍ ترتقي بالبلد وبالمنظومة التربوية، وتخضع للمراجعــة المستمرة والنقد الحصيف. الخيار الأول هو واقع مدرستنا، والخيار الثاني هو ما إليه نصبو، وما ينبغي أن تتعبّأ له الطاقاتُ جميعُها.
الثورة الثقافية
وينقل حسن أوريد عن المربّي والخبير محمد شفيق قولَه: إنّ بناء الإنسان سابقٌ على أيّ شيء في مسارب الحضارة، وأنه لا يغني أن ينقل الإنسان التكنولوجيا أو ينبهر بنتاجه المادي ويُغفل التربية. يرى المؤلف أن مسألةَ إصلاحِ هذه المنظومة أعقدُ من أنْ تُحصر في المسار التعليمي وحده، ولن تنجح المدرسة، مهما أوتيت من إمكانات، ما لم تنخرط الأسرة وفعاليات المجتمع، وما لم تتغير الثقافة السائدة في الأسرة والمجتمع، وتتضافر جهود فعاليات المجتمع وقواه الحية وأدوات الدولة. فلا غرو إن وجدناه يخصص فصولا للتدبير الإداري وترشيد الموارد، وللأسرة، ولمؤسسات الدولة من وزارات التربية الوطنية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة، الشباب والرياضة، والجماعات الترابية، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
من الأهمية بمكان أن نُقرن التربية بالمواطنة، ولكن يتعيّنُ أن نحدد مدلولها، ونُرسيَ البنيات التي من دونها لن تقوم، وأوّلها المواطن، أي شخصٌ له حقوق وعليه واجبات. ولا يمكن أن نتحدث عن مواطنة في ظلّ مفهوم الرعية، يُعزل الشخص لغير سبب، وتُمنح الإكرامية لغير وجه، ويغتني شخص بناء على ريع تمّ التفضل به عليه وليس جُهدا قام به، ويُرفع من شأن شخص بلا موجب حق، ويُزرى بآخر لنزوة. لن تقوم المواطنة إلا في ظل دولة القانون أو حالة القانون التي تتنافى وفعل الأمر، أي كل تصرف يَصدُر عن نزوات أو اعتبارات ذاتية من منطلق الحكم المطلق؛ يوضح حسن أوريد.
أما المرتكز الثقافي لفلسفة التربية، فيتجلى في تنصيص المؤلف على أنه من العسير أن تتغير مدرستنا في ظل ثقافة تقليدية محافظة تؤمن بالخرافات، وتدفع إلى الضحالة، والإيمان بالأشخاص، أو على الأصح الارتباط بها بناء على المصالح، عوض الإيمان بالمفاهيم والمبادئ والأفكار، وفي ظل بنيات لا تقوم على الكفاءة وتعتمد الولاء، بيد أن المجتمعات تفرز ديناميات تهزأ بالسلوكات المثبطة مهما نفذت في النفوس واستقرت في الأذهان، وتزعزع البنيات التقليدية ــ على قوتها ــ بل تزيحها. ألم تزح فلسفة الأنوار الكنيسة؟ ألم تقوض من أثر التقاليد ومن الارتباط بالأشخاص؟ ومن أجل ذلك، نراهن ــ هنا ــ على الدينامية الإيجابية التي تعتمل في المجتمع المغربي، وليس على إصلاحات سطحية تُبقي على الممارسات المتفشية والسلوك المستشري والبنيات القائمة.
ويؤكد المؤلف أن الثورة الثقافية التي ننشدها تفترض قطيعة، قطيعة مع ما نعتبره من المسلَّمات وقطيعة مع أساليبنا في العمل، التربية في المجتمعات التقليدية تربية محافظة، أما التربية الحديثة فهي بطبيعتها متجددة، ولذلك فهي متمردة. ونحن لم نحسم بعد في شأن طبيعة التربية التي نريد، أهي محافظة أم حديثة؟ ويفصل في مواصفات ما يُطلِق عليه «الطموح الجماعي»، بالقول: نريد أن نكون أمّة متحدة في أهدافها، منسجمة في مكوّناتها وإن اختلفت تعبيراتها، نريد أن نكون دولة قوية بمؤسساتها، لا مكان فيها للنزوات والأهواء، نريد مجتمعا يستهدي بالقيم ويجعل مدارَ التميز الإبداعُ والعطاءُ ويأتمُّ بالجد، لا مكان فيه لمجد الحظوة، ولا ينزع لإغراء المادة أو النزوات والعبث.
نريد من المدرسة أن تكون جسرا لهذا الهدف المنشود، لا نريدها انعكاسا لمجتمعنا تحمل عيوبه واختلالاته. لذلك، لا بد من ثورة ثقافية تكون فيها المدرسة قاطرة لا مقطورة، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان للمجتمع طموح جماعي يسعى إليه ويتجند لبلوغه. طموح يقوم على قيم أكثر منها على تقنيات، يحملها ذوو العزم من أبناء الأمة، ويحملون السلطة العمومية على تبنيها. طموح جماعي يرسخ الشعور بالانتماء المشترك إلى الأمة وتعزيز بناء الدولة. إذ من العبث أن نتحدث عن إصلاح المنظومة التربوية إذا لم يكن لنا طموح جماعي، من إيمانِ بأمّة جامعة، ودولة مُؤتمنة على عَقد جماعي، وقيم ماسكة، وثقة بين مكوناتها، وغاية مرسومة، وسبيلٍ محددة المعالم.
نحن لا نستطيع أن نختزل التربية في منظور تقني، أو رؤية قطاعية، خاصة بالنسبة للمجتمعات التي تعاني الجمود الفكري وترزح تحت وطأة التقاليد وهيمنة الأسر النافذة والطبقات المتنفذة، وترتبط بتبعية اقتصادية وثقافية لمراكز أجنبية.
يطرح الكاتب أســـئلة وجوديـــة، من قبيل: من نحن؟ حيث يبحـــث في مكـــونات الشخصـــية المغربيـــة، ومــا الذي نريده؟ فيجيب: نريد أن نكون جــزءا من التجربة الكونية، ونستوعب ما انتهت إليه، أي الانتماء إلى روح العصر والتشبع بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والإيمان بالآخر، والابتعاد عن الاستبداد والتقاليد المستشرية. إنّ التربية ـ كما يقول ـ لا يمكن أن تكون استنساخا لطرائق مضت لعهود ولّت، حتى لو كانت جيّدة في ســياق سابق، فهي غير مفيدة في سياقنا، ولذلك لا بد من أن نبرأ من الحنين حين نتحدث عن التربية، ونكفّ عن التغني بالعصر الزاهر للمدرسة (إن كان هناك من عصر زاهر)، وأن نحدد نوعية تعليمنا وفق العالم الذي نعيشه والسوانح التي يتيحها والمخاطر التي قد يحملها.
عقلنة التعليم
وحيث إنه لا يمكن إصلاح المنظومة التربوية بدون الانكباب على البرامج، فإن حسن أوريد يبسط تصوراته لمحتوى التدريس الموجه للتلاميذ، انطلاقا من مرحلة ما قبل التمدرس إلى مرحلة البكالوريا. ويركز على مبدأين أساسيين، هما الأخلاق، بالقول إن غاية المدرسة تربوية بالأساس، أي ترسيخ منظومة قيم لا تتعارض مع القيم الكونية، والشخصية الوطنية أو القَوَام الثقافي، من خلال التشبع بالعناصر المكونة للشخصية المغربية. وعند تناول المسألة اللغوية، يميل حسن أوريد إلى الطرح الذي ألح عليه الأنثروبولوجي عبد الله الحمودي، بالقول بضرورة إعادة النظر في تعليم اللغات والتخلي عن السياسات التي اعتُمدت لحد الآن، والحل يكمن في إصلاح وعقلنة تعليم اللغة العربية بموازاة مع تعليم الأمازيغية والانفتاح الدائم على اللغات الغربية، خاصة الإنكليزية والفرنسية. أما القيم الأساسية التي يُشترط أن ترتكز عليها المنظومة التربوية، فهي ـ بحسب أوريد ـ على النحو التالي:
1 ـ المساواة وعدمُ التمايز بين التلاميذ على أي أساس.
2 ـ الحرية، فأساس التفكير هو الحرية، لما تتيحُه من تفتقٍ للمواهب وإزاحةِ روح الاستبداد وترسيخ الشعور بالاستقلالية لدى الطفل، علينا ـ يقول المؤلف ـ أن نغرس في ذهنية الطفل أن الحرية وما يستتبعها من قيم فردية ليست مطلقة، فهي تقف مثلما يُقال عند حرية الآخرين ويحددها القانون، وتنبني أو ينبغي أن تنبني على المسؤولية. من الضروري المزاوجة بين الحرية والانضباط، ومن الأمور المرتبطة بالحرية هو الجنوح للحوار في عملية التربية.
3 ـ التضامن: ينصرف إلى العلاقات في داخل الفصل، إذ ينبغي للتنافس المحمود بين التلاميذ ألا يحجب التضامن في ما بينهم في شؤون مدرستهم. كما ينصرف إلى التضامن ذي الدلالات العميقة، التي ينبغي للبرامج التربوية أن تتضمنها وللمربّين أن يشجعوها، ومؤدّاه أن مكونات الشخصية المغربية مِلك للمغاربة قاطبة، في مختلف مكوناتها الأمازيغية والعربية والأندلسية والحسانية واليهودية والإسلامية وغيرها.
يقول المؤلف بهذا الخصوص: نحن إذ نتحدث عن المغاربة لا نتحدث عن عرق معين، لأن أعراقنا امتزجت، وإن لم تمتزج في أحايين أخرى، فهي ملتقية حول قيم مشتركة. كل دعوة عرقية هي بالضرورة عنصرية وينبغي لفظها. على الأطفال أن يدرَجوا على قيم مشتركة، ومنها الإيمان بأمّة واحدة، مهما اختلفت مكوناتها، انصهرت عبر التاريخ، والتحمت من خلال إيمانها بالمصير المشترك. ولكننا جزء من الحضارة الإنسانية، فلا يحسن بنا أن ننغلق في ما يسمى بالهوية. علينا أن ننفتح على الآداب العالمية والقيم الإنسانية. إن من شأن اختيار نصوص عالمية أن يبثّ في أذهان الناشئة الانفتاحَ وقبولَ الآخر، وتبني النسبية في الأحكام، وإدراكَ البعد الإنساني الثاوي في كل الثقافات وفي كل اللغات.